*الزاهيد مصطفى
1.
الفيلسوف
والسينمائي
تطرح العلاقة بين
الفلسفة والسينما في عالمنا العربي الكبير نوعا من التوتر بين فهمنا الكلاسيكي
للفلسفة وفهمنا المعاصر للسينما، وخاصة أن كلا من الفلسفة كما ورثناها في تراثنا،
لم تكن منشغلة سوى بقضايا فلسفية تراثية
ومستغرقة فيها، بينما السينما بوصفها مفهوما ينتمي إلى مابعد الحداثة دخيل علينا كما
دخلت علينا الحداثة. ومن باب الصدمة صرنا نجد نوعا من
التنافر بينهما، السينما بوصفها نمط تعبيري مابعد حداثي يقوم على الحركة والصورة
والتقنية، والفلسفة كما تمثلناها بوصفها خطاب وقول عقلاني ومفاهيمي، لكن المطلعين
على الفكر المعاصر والمنفتحين على روافده المتعددة لايجدون أي صعوبة، بل يحسون على
الأقل(وهنا أتحدث عن المتخصصين) بأن العلاقة بين السينما والفلسفة ممكنة، لكن الجمهور
الواسع اليوم يظل بعيدا عن إدراك طبيعة هذه العلاقة خاصة بين نمطين فكريين مختلفين،
الفلسفة و أداة اشتغالها المتمثلة في "المفهوم واللغة"، والسينما
التي تعتبر أداة التعبير عنها"الصورة والحركة والتقنية"،
وفي هذا
المقال سأسعى إلى تدليل هذه العلاقة بين الفلسفة والسينما مسترشدا بالأسئلة الآتية:
هل يمكن للفلسفة أن تجعل من السينما موضوعا للتفكير الفلسفي؟، وما الرابط الذي
يمكن أن نقيمه بين الفلسفة والسينما، علما أن
الأولى تفكر في العالم من خلال الصورة والفلسفة تفكر فيه من خلال المفهوم؟ ألا
يمكن القول أن وظيفة الفلسفة والسينما ترتبطان بكونهما تشتغلان بنفس الأدوات
المعرفية والذهنية وهي الخيال الخلاق والصورة والمفهوم واللغة؟، ألا تعيدنا السينما
اليوم إلى قلب الإشكال الأفلاطوني القائم على التوتر الحاد بين عالم الدوكسا
(المعارف المتغيرة والظنية والمتخيلة) وعالم الإيدوس(عالم المعرفة بالمثل الثابتة
وبالحقائق الخالدة)؟ أليست السينما تعبير جديد على ذلك الإنفصال التام بين الحدث
في الواقع وبين صورته في الذهن؟ أليس المخرجين السينمائيين فلاسفة بمعنى آخر، فإن
كان الفيلسوف يبدع المفاهيم وينحتها فإن المخرج السينمائي اليوم يبدع الصور
وينحتها لتشكيل عوالم جديدة للخيال والمتخيل؟.
المعروف أن أٍرسطو
قد نسب إليه يوما أنه لايمكننا أن نفكر بدون صور، فنحن لا نستطيع أن نعبر عن هذه
الصور في غياب اللغة، وإن كان السينمائي
يجد أداة تعبيره عن العالم في الصورة
والحركة والتقنية، فالفيلسوف يجدها في المفاهيم المجردة، لكن المشترك بين الفيلسوف
والسينمائي هو أن كل منهما يعبر عن العالم من خلال تصورات مجردة، تجد تعبيرها لدى
الفيلسوف في التجريد، ولدى السينمائي في التجسيد على مستوى الشاشة، هذا التوتر
القائم بين الفيلسوف والسينمائي عبر عنه الباحث الفرنسي "بيير يف
بورديل": في مقالة ترجمها عزدين الخطابي في كتاب يحمل عنوان "الفلسفة
والسينما" تحت عنوان ما الذي تفهمه الفلسفة من السينما؟، أقام بورديل
نوعا من التقابل الذي يحيل على التضاد
المطلق بين كهف أفلاطون وقاعة السينما، فسجناء الكهف الأفلاطوني مشابهين إلى حد ما من الناحية الشكلية للمتفرجين
من داخل قاعة السينما، لكن ماهية السجين الأفلاطوني مختلفة جذريا على ماهية المشاهد
في قاعة السينما، فسجناء الكهف الأفلاطوني سلبيون ووضعهم محدد سلفا، وأفعالهم
متوقعة، بينما مشاهد السينما مشارك ومنخرط
في الحدث بأفعاله وآنفعالاته، ويدرك بشكل قبلي أن ما يراه مجرد سينما، ولايعكس
الواقع والحقيقة بتاتا حتى وإن كانت احترافية المخرج قد جعلته يخلق نوعا من
المحاكاة بين المشاهد والصور والواقع الذي تحيل عليه أو تثيره لدى المتلقي. إن
السينما ترتبط بالمتعة واللذة والرغبة عند السينمائي، لكنها بالنسبة للفيلسوف
ترتبط بالمفهوم.
2.
عظمة
السينما وأفق مابعد الحداثة:
إن فهم الأحداث داخل الفيلم السينمائي لايمكن أن يتحقق إلا من
خلال النظر للأحداث في سياق الكل وهو العمل السينمائي، سياق الأحداث داخل الفيلم،
فالسينما فكر مابعد ميتافزيقي إستطاع أن يجمع بين الواقع والمثال، هذه القدرة لدى
السينما هي يجعلها قادرة على تجاوز مفهوم التطابق الذي قامت عليه الميتافيزيقا
الغربية منذ اليونان، وخاصة المنطق القضوي الذي كان يقوم على الإيمان بوجود مبادئ
في العقل تضمن له عدم الوقوع في الخطأ، من بينها مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث المرفوع، لنفهم هذه المبادئ لابد
من تذكير القارئ الكريم بها، يعني مفهوم الهوية في
التصور الأرسطي ما تقتضيه الضرورة المنطقية لكي تكون هناك قضية ما صادقة أو
كاذبة، ويقتضي مبدأ الهوية مبدأ التناقض
ومبدأ الثالث المرفوع، فمبدأ التناقض يعني أن الشيء لايمكنه أن يكون موجودا وغير
موجود في نفس الآن، وأما مبدأ الثالث المرفوع فيعني القول أن القضيتين المتناقضتين
لايمكن أن تكونتا صادقتين معا أو كاذبتين
معا،إن هوية الشيء هي خصائصه الثابتة التي لا تتغير مهما تغيرت أعراض وصور هذا
الشيء، فهوية الشيء هي ماهيته وجوهره وحقيقته الثابتة.
حينما
نعود إلى السينما نجدها في ماهيتها وبقدرتها على دمج كل من العلم والعقل والتقنية
في إنتاج تمثيلاتها للعالم قادرة على جمع المتناقضات، فالعقل القضوي الذي تأسس منذ
أرسطو واستطاع أن يندس في قلب التصورات التي أعطتها الحداثة حول العالم بإيمانها
بأن النقيضين لايمكنهما أن يجتمعان، لكن يمكنهما في التصور الهيجيلي أن يساهما في
تطور حركة التاريخ، نجد السينما استطاعت أن تجمع بينهما، ففي صيرورة الحدث
السينمائي يمكننا أن نلمس الجمع بين جميع التناقضات، مما يجعل العقل الأرسطي والأفلاطونية
الحاضرة في قلب تاريخ الفلسفة حائرة أمام قدرة وعظمة هذا الكهف الذي يلجه الناس في
القاعات أو يمكنهم مشاهدته عبر الشاشات أن يوحد بين المثال والنسخة، بين الواقع
والمثال، ففي فيلم بعنوان Resident Evil الذي
أدت الدور فيه "ميليا جوفوفيتش"
والذي تدور أحداثه حول مؤسسة للهندسة
الحيوية والوراثية تعمل على إنتاج سلاح بيولوجي يتمثل في خلق بشر أقوياء بقدرات ومورثات جينية قوية، لكن ظهور مشكلة تقنية ستجعل الفيروس المخصص
لتعزيز هذه الجينات يؤدي وظائف عكسية أدت إلى التأثير في القدرات العقلية للبشر مما
أدى إلى إنتشار الفيروس بسرعة هائلة مما جعل البشر أكثر توحشا مما كانوا عليه من
قبل، لكن شخصية "أليس" باعتبارها الأمل استطاعت أن توجه جماعة الناجين
نحو بر الأمان معتمدة على ذكائها الجيني الخارق وقدراتها البدنية العالية، وذلك
نظرا لكونها أهم المنتجات التي نجحت منظمة الخلية التي كانت تشرف على تلك الأبحاث
في إنتاجها، لكنها لم تستطع أن تكرر نفس النجاح في باقي النسخ الأخرى من شخصية
"أليس" الخارقة بطلة الفيلم، وهو ما كان يؤذي الى تشوهات باستمرار.
إن
القارئ العادي الغير المسلح بالعدة المفاهيمية وبخلفية معرفية فلسفية وثقافية متينة
سينظر للفيلم السينمائي ولأحداثه هنا باعتبارها مجرد إبداعات للخيال العلمي، أو
ستتحرك عواطفه ليستمتع بمشاهد العنف والقوة التي تملكها بطلة الفيلم "أليس"
ويخرج من القاعة، أو ينهي الفيلم على شاشة حاسوبه، أو تلفازه، وقد مارس نوعا من
التطهير، وحقق بعض الفرجة، واللذة منبهرا بالأداء والمشاهد ودقة الحركات في
الفيلم، لكن الفيلسوف سيكون له رأي آخر فهو بعيد عن نظريات النقد السينمائي التي
تقتضيها صناعة السينما -وهو نقد يمارس لدواعي تجارية محضة في المهرجانات العالمية- سيكون اهتمامه الأساسي منصبا على التأويل والتمثيل،
بمعنى سيكون همه هو قدرة هذا الحقل الذي يصعب أن نوصفه بالفن لأن الفن مرتبط
بالذوق، والسينما اليوم تجاوزت الذوق والحكم الجمالي لتصير أداة ضخمة لإبداع
تصوراتها الخاصة على العالم، لهذه الدواعي سينصب الفيلسوف على الحقيقة والسلطة والإنسان
وميتافيزيقا الواقع الذي تخلقها السينما وتتجاوزه في نفس الوقت.
3. السينما مسكن العالم ومأوى
الكائن:
كان
مارتن هايدغر يعتقد أن اللغة هي مأوى الكائن
ومسكن الفكر، ومن لا لغة له لا فكر له، فقدرتنا على التفكير مرتبطة بقدرتنا
الهائلة على تملّك اللغة، لكن أستطيع الزعم اليوم أن السينما استطاعت أن تتجاوز
عقم اللغة وعجزها أحيانا على التعبير والتمثيل على الفكر وعلى مضامينه، فصارت
السينما اليوم هي مأوى الفكر ومسكنه، بفضل الإتحاد بين العقل والتقنية والصورة، فالسينما
اليوم قادرة على التعبير عن الفكر أفضل تمثيل يقربه إلينا وكأنه حقيقة، فمثلا لم
يكن من الممكن أن نتصور حقيقة الإستنساخ وكذلك أن نستوعب عمق وخطورة النقاش الذي
دار بين الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايك في كتابه حول الحظيرة البشرية ويورغن
هابرماس في كتابه حول نسالة ليبرالية لولا فيلم The
Island الذي عالج ظاهرة الإستنساخ
في مختلف أبعادها وشروطها منتصرا للنزعة الإنسانية التي تعتبر الوعي تجربة ذاتية
لاتقبل الاستنساخ، كما وجه نقدا لاذعا
للنزعة العلمية المحضة التي تعتبره مسألة ضرورية لتحسين شروط عيش وتطور النوع الإنساني
جينيا، من هنا يمكن القول أن التحذير من الإستنساخ سيجد صدى كبيرا له حينما حولته
السينما إلى "كائن مفهومي مشخص" قابل للتمثيل والتمثل من طرف
المناهضين له لدواعي حقوقية وسياسية، وهنا تتجلى عظمة السينما، فإذا كان كارس
ياسبرز قد تحدث في كتاب له عن "عظماء الفلاسفة" و عن عظمة الفلسفة
ومجدها، فيمكنني القول أننا اليوم مطالبون في من داخل الفلسفة بالحديث عن عظمة
السينما أيضا.
4. السينما والتربية والنزعة الإنسانية:
لايوجد
بلد اليوم لا يطرح بحدّة وبشكل جدي القضية التربوية على مستوى جميع البلدان وخاصة
على مستوى العالم العربي الكبير من بلاد فارس إلى شمال إفريقيا، فبخصوص المشكلات
التربوية يتم التركيز في الغالب على الأمور المحيطة بالعملية التربوية، وخاصة ماهو
تقني، لكن السينما استطاعت أن تشخص مشكلة التربية وعوائقها الثقافية والسياسية في
مسألة بسيطة وهي (غياب أساتذة ملهمين)، وهو ما جسده الفيلم العميق "ابتسامة
الموناليزا"، الذي تم عرضه سنة 2003 من إخراج ميك ناويل/
بطولة الجميلة جوليا روبرت وكريستين دنيست،
الإشكال الذي يدور حوله الفيلم يمكن تلخيصه في
السؤال التالي:هل بإمكان المدرسين تغيير العالم أو لنقل كسر القواعد
المسلم بها و توجيه المجتمع نحو مثل أسمى؟
يحكي الفيلم Le
Sourire de Mona Lisa قصة
"كاثرين" أستاذة لتاريخ الفن بجامعة ويسللي، كانت في سنة 1949 تدرس
العديد من الزيجات اللواتي يحصرن غايتهن من الحياة في الحصول على زوج، لم يكن مطمح
كاثرين مناهضة هذا الخيار بقدر ما كان يهدف إلى إظهار أن الحياة أكبر من اختزالها
في هدف بيولوجي محض يعيد إنتاج المجتمع، شنت جماعات البحث العلمي في الجامعة من أساتذة
وإداريين حروبا من الإشاعات على كاترين، مع الوقت ورغم صرامتها إزداد طلبة كاترين
التي ستتعرض للتوقيف من عملها بسبب علاقتها الشخصية مع طالباتها وتأثيرهن الحقيقي
في تصوراتهم وقيمهم ونظرتهم للعالم، لم يدم التوقيف كثيرا حيث عرف الموسم الجامعي
تسجيل العديد من الطالبات في شعبة تاريخ الفن وهو ما إضطر رئيسة الجامعة لمراسلة
كاترين قائلة:
"العزيزة
كاثرين نريد عودتك لتكوني من فريق البحث وهيئة التدريس بجامعة ويسللي التي لديها
تقاليدها الأكاديمية العريقة، لكن شريطة أن لا يتضمن درسك تقديم أمثلة أو نماذج
حياتية، أو أراء خاصة في قضايا خاصة، كما نطالبك بتقديم دروسك بشكل مسبق لتخضع
لرقابة الجامعة والموافقة عليها"
كان رد كاترين التي بدأ طلبتها بالتكاثر بعد
تفكير ملي حفاظا على انسجامها مع خياراتها: اسمحوا لي لا يمكنني في النهاية أن
أنتمي لتقليد يضع مجموعة من القواعد من وجهة نظري تؤخر تدريس الفن أكثر مما تفيده،
إن غاية التدريس هو في النهاية كسر للقواعد المسلم بها، وإعطاء الفرصة للطلبة لكي
يؤسسوا قواعد جديدة، لذلك لا يمكنني العودة للتدريس بشروط، لأنني سأكون غير منسجمة
مع مبادئي ومواقفي وشرط التدريس هو الحرية.
تكمن عظمة
السينما في قدرتها على قول أهم شيء حول أعقد الإشكالات الوجودية للإنسانية،
فعظمتها تكمن في نزعتها الإنسانية.
*أستاذ مادة
الفلسفة وطالب باحث
*منشور في العدد 16
من مجلة أفكار
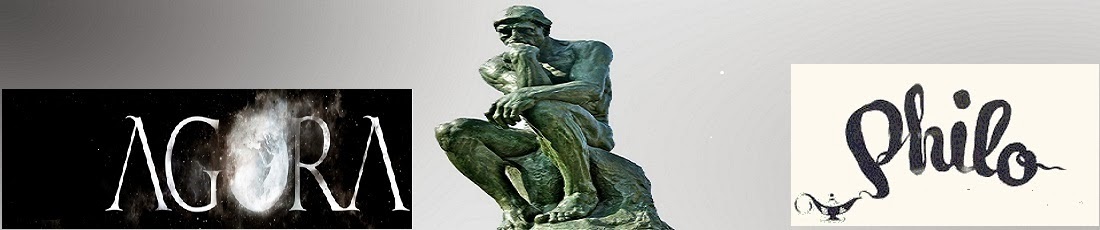

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق